
إلى ما قبل فترة الثمانينيات الميلادية لم تكن العلاقة بين أفراد مجتمعنا قائمة على أية مفاصلة تصنيفية من أي نوع كانت هذه المفاصلة، بل كان الكل في نظر الكل مسلمين لهم من الحقوق مثلما عليهم من الواجبات، وكان جل ما يمكن أن يوصم به المخالف بينهم أنه مقصر ينبغي تنبيهه وتوجيهه برفق.
مع بزوغ فجر الثمانينيات الميلادية وبروز الخطاب الصحوي ذي الصبغة الاخوانية، بدأت المفاصلة العلائقية مع مخالفيه تتضح معالمها كأحد أهم ثوابت بنية ذلك الخطاب التي يعتمد عليها في تسويق ذاته، وجاءت هذه المفاصلة العلائقية مرتدية ثوب حزمة تصنيفية تدشن لخطوط علاقات متوازية بين فريقين، أحدهما: فريق الإسلاميين - أقطاب الخطاب الصحوي ومن يناصرونه - وثانيهما: كافة من لا يتفقون مع أيديولوجية ذلك الخطاب ممن أصبحوا يمثلون "الآخر" بالنسبة له، والذي بات أحدهم يوصم بأنه إما علماني أو تغريبي أو انبطاحي أو عصراني، وكلها وإن اختلفت مسمياتها فمضامينها ترمز إلى أن من يوصفون بها ضُلاَّل حائدون عن الصراط المستقيم يبتغون الضلالة ويريدون للمسلمين أن يضلوا السبيل !!!.
من بين كل تلك التصنيفات المحملة بإرادة تعميق المفاصلة والمباعدة بين أفراد المجتمع، برز مصطلح "علماني" ك "أحدِّ" الأسلحة التي أشهرها الصحويون في وجوه مخالفيهم، ومن فرط تسويقهم لهذا التصنيف وأخذه كخط مفاصلة لا يقبل التماس مع مخالفيهم، فقد شاع واشتهرعلى ألسنة مسوقي ذلك الخطاب، بل وأخذ الكثير من عامة الناس ممن اقتات على "حصرم" مخرجات ذلك الخطاب يطلقونها على كل من يشتمّون منه أدنى مخالفة للمفاهيم السائدة، حتى ولو كانت من قبيل العادات والتقاليد.
ولأن مصطلح "علماني" أصبح بعد هذا التوطين الصحوي قرينَ الكفر والفسوق والمروق من الدين، فكان لا بد بالتالي من الدخول على خط تفكيك معناه، لتبيان مدى البراغماتية السياسية التي أراد ذلك الخطاب تحقيقها من وراء إشاعته مفهوماً خاطئاً للعلمانية، بتحويلها من مصطلح "جمعي" إلى مصطلح "فردي" استشرافاً لغايات سياسية لا تتحقق إلا بإحالة المجتمع شيعاً يكفر بعضه بعضا.
مصطلح العلمانية نشأ تاريخياً في أوروبا كمفهوم سياسي لمحاربة الكهنوت الكنسي ومن ورائه الإقطاع الذي كان جاثماً على صدور الأوروبيين طوال العصور الوسطى، إذ كانت السلطة الزمنية بتوجيه من السلطة الروحية، تضطهد الأقليات الدينية والمذهبية المخالفة للمذهب المسيحي السائد(الكاثوليكية) إضافة إلى "قسر" المسيحيين الكاثوليك على تفسير وحيد للدين، بجانب "تديين" العلم ومحاربة نتائجه المتعارضة مع المفهوم الديني المسيحي للظواهر الطبيعية - دوران الأرض حول الشمس مثلاً مقابل المفهوم الكاثوليكي المعكوس - وهنا كان لا بد للفكر السياسي الغربي من اختراع بديل ينقذ المجتمع من مآسي الحروب الدينية التي أكلت حينها الأخضر واليابس، عن طريق رفع سوط الكنيسة عن رقاب الناس، إضافة إلى إفساح المجال للعلم ليقرر نتائجه الموضوعية بعيداً عن رقابة الكنيسة، فكان أن أختُرِع مصطلح العلمانية الذي يعني تحديداً "حيادية" الدولة تجاه الأديان والعقائد والمذاهب المختلفة في المجتمعات المتعددة، بجانب حيادها أيضاً تجاه التفسيرات المتعددة للدين الواحد، مع ضمان "دنيوية" العلم، وهو ما تم التعبيرعن مفهومه الشامل ب "فصل الدين عن الدولة" وليس كما يروج له الخطاب الاخواني والصحوي بأن العلمانية تعني "فصل الدين عن المجتمع والحياة"، الذي لم يتحقق أصلاً ولن يتحقق مستقبلا، سواء في أوروبا أوفي غيرها من المجتمعات الأخرى إذ يبقى الدين حاجة إنسانية لا تنفك عن الفرد بحال، وسيبقى ما بقي إنسان على هذه الأرض كما أثبت ذلك علم الاجتماع الديني.
أثمر التطبيق السياسي للعلمانية في أوروبا عنصرين سياسيين مهمان، أولهما: تحرير "المواطنة" التي أصبحت الدول بموجبها ترعى شئون شعوبها بصفتهم "مواطنين" فيها بعيداً عن أديانهم وأعراقهم وألوانهم ومذاهبهم، وثانيهما: تحرير العلم من أسر الكهنوت الكنسي وإطلاق يديه في آفاق الطبيعة، يضع فروضه كما يشاء ويختبرها كيف يشاء ويعلن نتائجه كيفما تتحقق بعيداً عن شروط الكنيسة، مما حقق له تلك القفزة الرائعة التي آتت ثمارها للبشرية كافة.
هنا بغض النظر عن اختلاف أو تشابه الظروف التي تحققت فيها العلمانية في أوروبا مع أوضاع العالم الإسلامي، إلا أن الذي يهمنا من هذا العرض بيان أن العلمانية كما رأينا آنفاً تعبر عن صفة للدولة أو النظام السياسي فيها، فيقال "نظام حكم علماني" تمييزاً له عن "نظام الحكم الديني"، ولا يصح بالتالي إطلاقها على الأفراد أو المنظمات، قد يصح مثلاً أن يقال عن حزب ما إنه حزب علماني، إذا كان يضع في برنامجه السياسي تطبيق العلمانية فيما لو وصل إلى الحكم، أو أنه يدعو الحزب الحاكم أو الدولة القائمة إلى تطبيق العلمانية، ولكن لا يمكن أن يقال عن شخص ما إنه علماني، لأنه ليس مناطاً به مثلما لا تتوفر لديه إمكانات تطبيق العلمانية، وهكذا كما نرى فلا مجال لوصف أي فرد أو منظمة أو جماعة ما بأنهم علمانيون، كما يتضح وفقاً لذلك أيضاً تهافت منطق الخطاب الصحوي وقبله ربيبه الاخواني وبراغماتيتهما الحدية عندما يفاصلون مخالفيهم على أساس العلمانية.


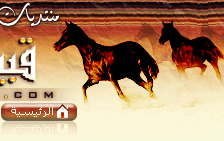










 العرض العادي
العرض العادي
